الجزائر: قراءة نقدية في سردية عبد الرزاق مقري حول غزة والمسيرة الشعبية
- cfda47
- 26 يوليو 2025
- 3 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2025

في منشورٍ مطوّل يحمل طابعًا وجدانيًا وسياسيًا، يروي عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، تجربته الشخصية في محاولة المشاركة في "مسيرة عفوية" تضامنية مع غزة. وبين خيبة الأمل في الواقع السياسي الجزائري، وتفكك الحراك الشعبي، يطرح مقري سردية تتأرجح بين الإحباط والإصرار. لكن هذا النص، رغم صدقه العاطفي، يستحق قراءة نقدية تضعه في سياق أوسع من التجارب التاريخية المشابهة، وتفكك بنيته الخطابية.
في مقال يشبه البوح الشخصي، يروي عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة "حمس" الجزائرية، تجربته بعد صلاة الجمعة في محاولة للانخراط في "مسيرة عفوية" تضامناً مع غزة. وبين خيبة أمله في الواقع السياسي، ومراجعة داخلية عن علاقة الخطاب الديني بالقضايا الكبرى، ينسج سرداً يعبّر فيه عن أمل متجدد رغم الصدمات. لكن النص يثير عدة تساؤلات نقدية حول الأداء السياسي، تحميل الآخر المسؤولية، ورومانسية التوقعات الجماهيرية.
عبد الرزاق مقري يستعرض تجربة ذاتية ويحمّلها دلالات سياسية أكبر من حجمها. عدم قيام المسيرة لا يعكس بالضرورة خنوعاً شعبياً شاملاً، بل قد يرتبط بالحسابات الأمنية أو غموض الدعوة. تحويل "محاولة فردية" إلى حكم شامل على الشعب الجزائري هو تبسيط مخل.
الفرد مقابل الجماعة:
هل تكفي النوايا؟ يقدّم مقري نفسه كفاعل سياسي يسعى إلى التعبير عن التضامن مع غزة، لكن غياب الحشد الشعبي وتحفّظ المصلين يضعه أمام واقع سياسي واجتماعي أكثر تعقيدًا. هذا التناقض بين الرغبة الفردية والجمود الجماعي يعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية مثل:
انتفاضة الخبز في تونس (1984): بدأت كمظاهرات عفوية ضد ارتفاع الأسعار، لكنها قُمعت بشدة رغم شعبيتها.
احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا (2018): انطلقت من مطالب اجتماعية دون قيادة حزبية، لكنها فرضت نفسها على المشهد السياسي الفرنسي.
في كلا المثالين، كانت العفوية نقطة انطلاق، لكنها تطلبت لاحقًا تأطيرًا جماعيًا واستمرارية لتتحول إلى قوة ضغط حقيقية.
الإمام كرمز ديني في مأزق سياسي:
النص يصور السلطات الأمنية كقوة قمعية محتملة، دون الإشارة إلى تعقيدات السياق الأمني أو القانوني. كما أن التلميح إلى توجهات الإمام (كالمداخلة أو العلمانية) دون أدلة، يطرح إشكالية الحكم على النوايا بناء على افتراضات أيديولوجية، مما قد يُساهم في خلق انقسامات وهمية.
ينتقد مقري الإمام الذي لم يدعُ لغزة، ويطرح احتمالات أيديولوجية (علماني، مدخلي، غير مبالٍ). هذا التوصيف يفتقر إلى الدقة ويُسقط الأحكام على النوايا دون تحقق. في السياقات التاريخية، لطالما كان الخطاب الديني أداة تعبئة أو تهميش، كما حدث في:
ثورة إيران (1979): حيث لعب رجال الدين دورًا محوريًا في الحشد الشعبي.
الربيع العربي (2011): حيث تفاوتت مواقف الأئمة بين التحريض والتزام الحياد، بحسب السياق السياسي المحلي.
غياب الدعاء لا يعني بالضرورة خيانة القضية، بل قد يعكس تعقيدات العلاقة بين الدين والدولة في الجزائر.
خطاب الإحباط:
يُلاحظ الطغيان العاطفي في وصف غزة، الحشود الأمنية، وحتى حوار المسجد. الخطاب يستنهض مشاعر القارئ، لكنه يفتقر إلى تحليل سياسي رصين أو تقييم موضوعي لأسباب تعثر الحراك الشعبي، ما يحوّل النص إلى نوع من المناجاة بدل المرافعة السياسية.
بين التراجيديا والتعبئة يُشبّه مقري خيبته بموقف محمد بوضياف حين قرر الانسحاب من السياسة بعد وفاة بومدين. هذه المقارنة، رغم رمزيتها، تنطوي على مبالغة. فالمسيرة الفردية لا ترقى إلى قرار سياسي بحل حزب. في المقابل، التاريخ مليء بأمثلة عن تحولات سياسية بدأت من لحظات إحباط:
محمد البوعزيزي (2010): إحراقه لنفسه كان فعلًا فرديًا، لكنه فجّر ثورة شعبية أطاحت بنظام بن علي.
الحراك الجزائري (2019): بدأ برفض ترشح بوتفليقة، وتحول إلى حركة جماهيرية واسعة.
الإحباط قد يكون شرارة، لكنه يحتاج إلى بنية تنظيمية ليصبح فعلًا سياسيًا مؤثرًا.
الأمل المحدود:
هل يكفي التظاهر؟ ينهي مقري منشوره بأمل في استمرار التعبئة، رغم محدودية المسيرات وتوقيف بعض المشاركين. هذا الأمل، رغم أهميته، يبقى هشًا ما لم يُترجم إلى استراتيجية واضحة. التجارب التاريخية تُظهر أن:
الثورة الفرنسية (1789): بدأت باحتجاجات شعبية، لكنها تطورت إلى تغيير جذري في النظام السياسي.
سقوط جدار برلين (1989): لم يكن نتيجة مسيرة واحدة، بل تراكم احتجاجات ومطالبات على مدى سنوات.
المسيرة العفوية قد تكون بداية، لكنها ليست نهاية الطريق.
نص منشور عبد الرزاق مقري يعكس صدقًا عاطفيًا ورغبة في التعبئة، لكنه يفتقر إلى التحليل السياسي العميق، ويغلب عليه الطابع الفردي والانفعالي. في ظل السياق الجزائري المعقد، لا يكفي الحنين إلى زمن المسيرات، بل يجب التفكير في أدوات جديدة للتعبئة، تتجاوز العفوية إلى التنظيم، وتنتقل من الإدانة إلى الفعل. فالتاريخ لا يُصنع بالنية وحدها، بل بالإرادة الجماعية والوعي الاستراتيجي.
قد يكون النص صرخة عاطفية، لكنه بحاجة إلى توازن أكبر بين المشاعر والتحليل، وبين الأمل والإحباط، ليشكل فعلاً رؤية تغييرية لا مجرد مرآة خيبة.
نسرين ج

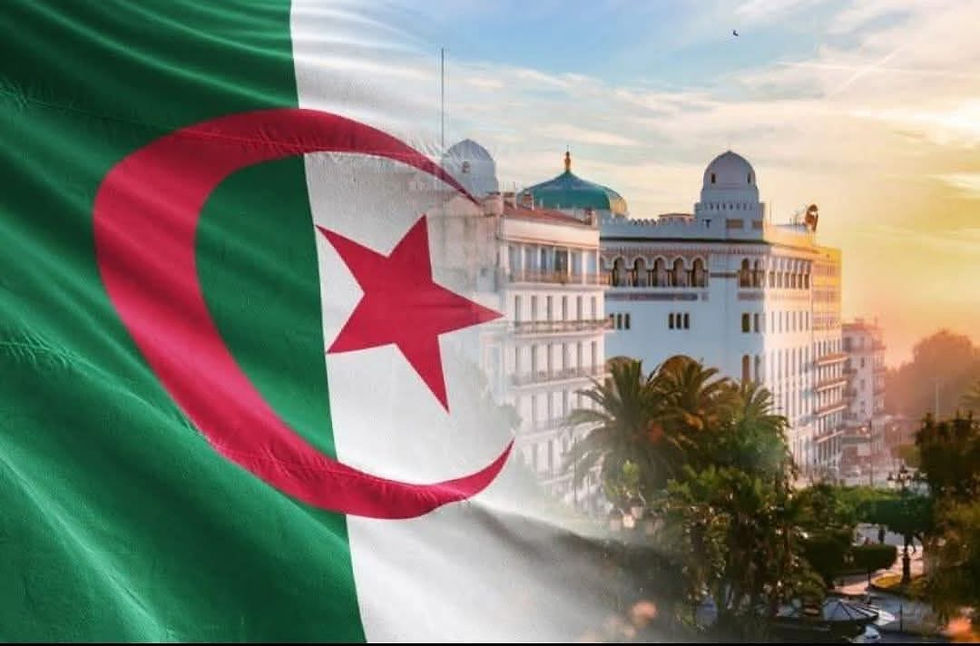
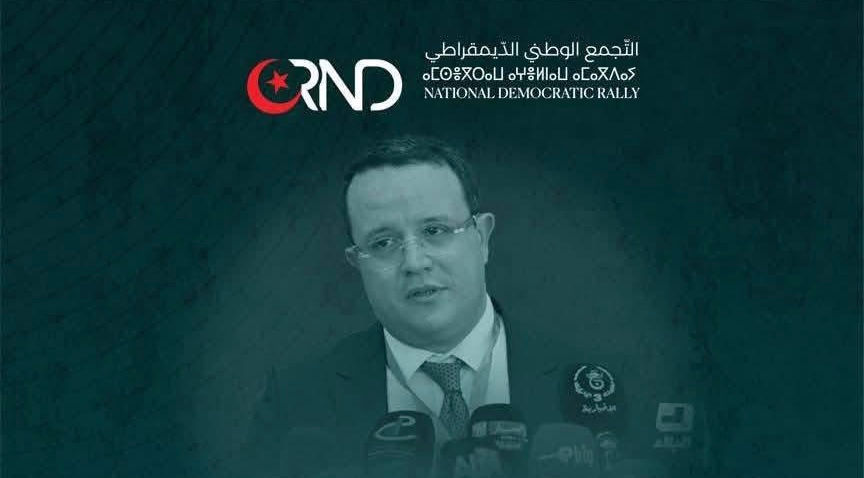
تعليقات